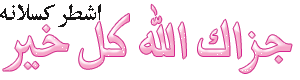الحرية والتغريب
إبراهيم المطرودي
لم يكن غريباً أن يفتح الإسلام للناس باب الحرية، ويدعهم وما يختارونه، فكل امرئ عن نفسه مسؤول، وليس للآخرين عليه من سلطة، سوى سلطة الموعظة الحسنة، إن كانت سلطة، لم يكن غريباً أن يكون الإسلام بهذه المثابة، وهو دين الأمم كلها، فعموم الرسالة يجلب معه الحرية؛ ذلك أن تعميم الرسالة بالغ الصعوبة، بل يكاد يكون مستحيلاً، وذاك شيء كشفه لنا ما عاناه الرسول عليه الصلاة والسلام في إقناع المقربين إليه! إذ لم يستطع بعد مضي ثلاثة عشر عاماً من الدعوة أن يجتذب سوى نفر من أهل مكة، مع أنّ أهلها كانوا يعرفونه تمام المعرفة، ويحفظون تأريخه فيهم، فتأريخ الدعوة يكشف عن صعوبة الإقناع، وغُضوا الطرف الآن عن أسبابه، وما دام الحال كذلك، فما من الغرابة أن يكون الإسلام دين الحرية، إنها الحرية التي تؤمن أنّ إقناع الناس، في أحيان كثيرة، بالواضحات أمر غير يسير! إنها الحرية التي من أجلها عاتب الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام قائلا: (لعلك باخعٌ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إنْ نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين).
لا يستطيع إنسان المذهبية أن يفكر مجرد تفكير في حرية الإنسان، أيا كانت تلك الحرية، وذلك منه صورة واضحة على شكه في المؤمنين بمذهبيته، التي يراها خلاصة الدين ونصوصه، وهو لهذا يسعى إلى ضرب فكرة الحرية من البداية، فيجعلها وجها من وجوه غربنة المجتمع..
ترك الله تعالى للناس حرية الاختيار، ولهذا عاتب حبيبه عليه الصلاة والسلام أن يهلك نفسه حزناً عليهم! فالهداية بيده وحده، ولو كانت الأمور بالإرغام لأنزل الله تعالى عليهم من السماء آية تُلجئهم كما يقول الشوكاني في تفسيره 4/ 93
إلى الإيمان؛ لكن قد سبق القضاء ألا يكون ذلك.
تلك كانت الحال يوم كان الإسلام بمبادئه هو الذي يقود الحياة، كان حريصاً على هداية الناس وصلاحهم؛ لكنه كان أيضاً حريصاً على حرية اختيارهم، وتلك هي المعادلة الصعبة، التي لا يستطيع المذهبي أن يتصورها، وحين سادت المذهبيات بمسلماتها بعد عصور التقليد لم يعد ثمة حرية، ليس في نطاق اختيار المذهبيات فقط، بل حتى في الخروج الجزئي الهامشي عليها، وتلك نقطة تتفق عليها جميع المذهبيات الإسلامية اليوم، ولهذا تجمع هذه المذهبيات على لوم الإنسان في خروجه عن مألوفاتها، وتبذل قصارى جهدها في إغلاق عينيه أن يرى غيرها، أو يفكر في تجربة سواها.
المذهبيات الإسلامية بمسلماتها الواهمة هي التي صاغت مفهوم الحرية، وفصّلته حسب منظومتها، وهي التي تسعى عبر ذلك التفصيل لتأسيس الموقف منها، وكيف يستطيع الإنسان المذهبي المقلد، الذي لا يرى بديلاً عن مذهبيته أن يكون صاحب موقف عدل في قضية الحرية، وكيف يستطيع هذا الإنسان المحشور في زواية المذهبية أن يقدم تصوراً مقبولاً أو شبه مقبول من قضية التغريب؟
كل ذلك ليس في مقدور هذا الإنسان، ولا في طاقته، (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)، وفي التراث الشعري الحكيم قول الشاعر:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ..... ولكن عين السخط تُبدي المساويا
فطالما جرى النظر بهذا البيت إلى التعامل مع الأفراد، وهو يصدق تمام الصدق على موقفنا من المذهبيات الإسلامية، فالإنسان المسلم وخاصة في بيئاتنا غير قادر على النقد والإصلاح؛ لأنه من الأساس لا يرى عيباً؛ إذ لا يستطيع المحب رؤية عيوب محبوبه، فكيف إذا وصلت به الحال كما في المذهبيات إلى العشق والوله؟ إنّ مطالبة إنسان كهذا بالنقد والإصلاح والمراجعة من باب تكليف ما لا يُطاق! ولهذا ترتسم في أفقي الحكمة البالغة، والمترامية الأطراف، لهذه الآية الباهرة التي تختزل تجربة الإنسان وتأريخه مع الأفكار حين أحاور مذهبياً، أو أقف في موقفه، وتلك حكمة من حكم الإسلام العظمى، التي غفل عنها إنسان المذهبيات، فصار يعمل بوحي من مذهبيته في جبهة أخرى، هي جبهة تكليف الناس ما لا يطيقونه فكراً وسلوكاً، وهكذا صارت المذهبية بما فيها من صغار الأمور وكبارها معقولة جداً! أمام أصحابها، وفي عيونهم، وصار التكليف بها من باب تحصيل الحاصل، ومن لا يؤمن بهذا فهو مشكوك فيه، ان قد نزعه عرق من الغرب أو الشرق!
تلك الآية الكريمة وأمثالها تضع بين أيدينا إطاراً فكرياً وتفسيرياً، يحسن بالمسلم أن يتخذه في النظر إلى مخالفيه، وفي تفسير مواقفهم، سواء عاشوا في القديم أم الحديث، فالتنوع الفكري في تأريخ الإسلامي، والقبول به والاحتفاء بممثليه، صادر من وحي هذه الآية الكريمة؛ لكن المسلم حين أضحى مذهبياً، يرى في مذهبيته القدرة على الإقناع؛ لوضوح قضاياها لم يعد قادراً على الاستظلال بظلال هذه الآية، وبهذا أعطى إنسان المذهبية مذهبيته شيئاً، لم يعطه الله تعالى للإسلام نفسه!! وانقاد هذا الإنسان تحت ضغط النصوع في مذهبيته وفطريتها وإنسانيتها إلى سوء الظن بمن يخالفه، والنظر إليه كخارج عن الدين والمنطق والعقل حين رفض هذه المذهبية أو بعض ما فيها، وكل هذا وغيره من ثمار المذهبية التي تُعلمنا أنْ ليس فيها شيء يصعب فهمه وقبوله إلا إذا كان رائدنا العناد والعنت والهوى!
ومن طريف تناقضات المذهبيات عندي أنها ترى مخالفها ظلوماً جائراً عن الجادة؛ لوضوح الحق فيها ونصوعه، ثم تنظر إلى أتباعها أصحاب هذا الحق الواضح والناصع نظرة الريبة والشك وسوء الظن، فتحول بينهم وبين أي انفتاح على مخالفيهم، أصحاب المذاهب الواضحة البطلان، والبينة العوار، وتسعى جاهدة عبر ممثليها أن ينأى المؤمنون بها عن ترهات الآخرين وغباواتهم، فإذا كان هذا شأنها، فأين دعواها في تلك الأوصاف التي تُطلقها على مذهبيتها؟ انظر إليها كيف أصبحت تشك في الإنسان، معها أو ضدها، وهي التي لا ترى بديلاً عنها يُقنع العالمين، ويهديهم سبيل الرشاد؟ إنها للأسف تدعي الإقناع، وهو شيء لم تستطع أن تدلل عليه من خلال موقفها من أقرب المقربين إليها حين شكت فيه، وجعلته تحت كاميرا المراقبة أن تزوغ عينه هنا أو هناك.
لا يستطيع إنسان المذهبية أن يفكر مجرد تفكير في حرية الإنسان، أيا كانت تلك الحرية، وذلك منه صورة واضحة على شكه في المؤمنين بمذهبيته، التي يراها خلاصة الدين ونصوصه، وهو لهذا يسعى إلى ضرب فكرة الحرية من البداية، فيجعلها وجها من وجوه غربنة المجتمع، فيقع بهذا التوصيف في تضليل أتباعه من وجهين؛ الأول تصوير الحرية كمفهوم غربي، ليس له وجود في تأريخ أمتنا، وهو شيء يُكذبه التأريخ بجلاء، ويكذبه تأريخ الإنسان المسلم مع نصوص دينه، والثاني نزع الغطاء الديني عن دعاة هذه الحرية، وإظهارهم بمظهر من يستند إلى الغرب وحده، ويسترشد بحياته، فتبدو الحرية كمفهوم دخيل على الثقافة الإسلامية، والحق عندي أنها دخيلة على الثقافة المذهبية، وليست الإسلامية، وهؤلاء المذهبيون في موقفهم مُحقون؛ لأنهم ينظرون من خلال كُوة المذهبية، وليس للحرية وجود في تأريخ المذهبيات، ولا في نصوصها؛ لكنهم أخطأوا حين خلطوا بين الإسلام ومذهبياتهم، فلعلهم ينظرون إلى الحرية من خلال رحابة الإسلام، لا ضيق المذهبية.
ولم يكتف إنسان المذهبية بغربنة قضايا الحرية الجديدة، وحجب الناس عن أن يفكروا فيها تفكيرا حراً، بل قصد، وهذا ما يكشف تمترسه بالمذهبية، ويُوضح غياب البوصلة عنده، ويفضح سعيه، إلى غربنة قضايا فقهية شهيرة، جرى فيها الخلاف بين المسلمين في القديم، وخير مثال على ذلك قضية حجاب المرأة المسلمة، حين أضحى من يقول بكشف وجه المرأة ساعياً من سُعاة تغريب المجتمع الإسلامي، وهكذا أضحى المذهبي يُعطّل نصوص الدين، ويحجب بعض منظومته من أجل أنّ هناك إنساناً يريد أن يتخذ هذه النصوص مدخلاً في تغريب المجتمع! وهكذا وقع المذهبي فيما يجهد للفرار منه، وهي التهمة التي ما زال هذا المذهبي يوجهها لمن يخالف بنود مذهبيته، ويستعين في بلوغ هدفه بمصطلح التغريب، نعم وقع المذهبي في الداهية التي يفر منها، وهي غربنة الإسلام، وقع فيها حين جعل للغرب دوراً في موقفه من نصوص دينه في قضية الحجاب، فهل يستطيع هذا المذهبي أن يُفسر كيف جاز له أن يتخذ الغرب حين نظره في النصوص، فيُوقف تلك النصوص المجيزة لكشف الوجه من أجل الغرب؟ وهل في مقدور هذا المذهبي أن يُفصح لنا عن الوقت الذي يجوز لنا أن نقول فيه بمقتضى تلك النصوص بعيداً عن غرب أو شرق؟!
إبراهيم المطرودي
لم يكن غريباً أن يفتح الإسلام للناس باب الحرية، ويدعهم وما يختارونه، فكل امرئ عن نفسه مسؤول، وليس للآخرين عليه من سلطة، سوى سلطة الموعظة الحسنة، إن كانت سلطة، لم يكن غريباً أن يكون الإسلام بهذه المثابة، وهو دين الأمم كلها، فعموم الرسالة يجلب معه الحرية؛ ذلك أن تعميم الرسالة بالغ الصعوبة، بل يكاد يكون مستحيلاً، وذاك شيء كشفه لنا ما عاناه الرسول عليه الصلاة والسلام في إقناع المقربين إليه! إذ لم يستطع بعد مضي ثلاثة عشر عاماً من الدعوة أن يجتذب سوى نفر من أهل مكة، مع أنّ أهلها كانوا يعرفونه تمام المعرفة، ويحفظون تأريخه فيهم، فتأريخ الدعوة يكشف عن صعوبة الإقناع، وغُضوا الطرف الآن عن أسبابه، وما دام الحال كذلك، فما من الغرابة أن يكون الإسلام دين الحرية، إنها الحرية التي تؤمن أنّ إقناع الناس، في أحيان كثيرة، بالواضحات أمر غير يسير! إنها الحرية التي من أجلها عاتب الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام قائلا: (لعلك باخعٌ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إنْ نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين).
لا يستطيع إنسان المذهبية أن يفكر مجرد تفكير في حرية الإنسان، أيا كانت تلك الحرية، وذلك منه صورة واضحة على شكه في المؤمنين بمذهبيته، التي يراها خلاصة الدين ونصوصه، وهو لهذا يسعى إلى ضرب فكرة الحرية من البداية، فيجعلها وجها من وجوه غربنة المجتمع..
ترك الله تعالى للناس حرية الاختيار، ولهذا عاتب حبيبه عليه الصلاة والسلام أن يهلك نفسه حزناً عليهم! فالهداية بيده وحده، ولو كانت الأمور بالإرغام لأنزل الله تعالى عليهم من السماء آية تُلجئهم كما يقول الشوكاني في تفسيره 4/ 93
إلى الإيمان؛ لكن قد سبق القضاء ألا يكون ذلك.
تلك كانت الحال يوم كان الإسلام بمبادئه هو الذي يقود الحياة، كان حريصاً على هداية الناس وصلاحهم؛ لكنه كان أيضاً حريصاً على حرية اختيارهم، وتلك هي المعادلة الصعبة، التي لا يستطيع المذهبي أن يتصورها، وحين سادت المذهبيات بمسلماتها بعد عصور التقليد لم يعد ثمة حرية، ليس في نطاق اختيار المذهبيات فقط، بل حتى في الخروج الجزئي الهامشي عليها، وتلك نقطة تتفق عليها جميع المذهبيات الإسلامية اليوم، ولهذا تجمع هذه المذهبيات على لوم الإنسان في خروجه عن مألوفاتها، وتبذل قصارى جهدها في إغلاق عينيه أن يرى غيرها، أو يفكر في تجربة سواها.
المذهبيات الإسلامية بمسلماتها الواهمة هي التي صاغت مفهوم الحرية، وفصّلته حسب منظومتها، وهي التي تسعى عبر ذلك التفصيل لتأسيس الموقف منها، وكيف يستطيع الإنسان المذهبي المقلد، الذي لا يرى بديلاً عن مذهبيته أن يكون صاحب موقف عدل في قضية الحرية، وكيف يستطيع هذا الإنسان المحشور في زواية المذهبية أن يقدم تصوراً مقبولاً أو شبه مقبول من قضية التغريب؟
كل ذلك ليس في مقدور هذا الإنسان، ولا في طاقته، (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)، وفي التراث الشعري الحكيم قول الشاعر:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ..... ولكن عين السخط تُبدي المساويا
فطالما جرى النظر بهذا البيت إلى التعامل مع الأفراد، وهو يصدق تمام الصدق على موقفنا من المذهبيات الإسلامية، فالإنسان المسلم وخاصة في بيئاتنا غير قادر على النقد والإصلاح؛ لأنه من الأساس لا يرى عيباً؛ إذ لا يستطيع المحب رؤية عيوب محبوبه، فكيف إذا وصلت به الحال كما في المذهبيات إلى العشق والوله؟ إنّ مطالبة إنسان كهذا بالنقد والإصلاح والمراجعة من باب تكليف ما لا يُطاق! ولهذا ترتسم في أفقي الحكمة البالغة، والمترامية الأطراف، لهذه الآية الباهرة التي تختزل تجربة الإنسان وتأريخه مع الأفكار حين أحاور مذهبياً، أو أقف في موقفه، وتلك حكمة من حكم الإسلام العظمى، التي غفل عنها إنسان المذهبيات، فصار يعمل بوحي من مذهبيته في جبهة أخرى، هي جبهة تكليف الناس ما لا يطيقونه فكراً وسلوكاً، وهكذا صارت المذهبية بما فيها من صغار الأمور وكبارها معقولة جداً! أمام أصحابها، وفي عيونهم، وصار التكليف بها من باب تحصيل الحاصل، ومن لا يؤمن بهذا فهو مشكوك فيه، ان قد نزعه عرق من الغرب أو الشرق!
تلك الآية الكريمة وأمثالها تضع بين أيدينا إطاراً فكرياً وتفسيرياً، يحسن بالمسلم أن يتخذه في النظر إلى مخالفيه، وفي تفسير مواقفهم، سواء عاشوا في القديم أم الحديث، فالتنوع الفكري في تأريخ الإسلامي، والقبول به والاحتفاء بممثليه، صادر من وحي هذه الآية الكريمة؛ لكن المسلم حين أضحى مذهبياً، يرى في مذهبيته القدرة على الإقناع؛ لوضوح قضاياها لم يعد قادراً على الاستظلال بظلال هذه الآية، وبهذا أعطى إنسان المذهبية مذهبيته شيئاً، لم يعطه الله تعالى للإسلام نفسه!! وانقاد هذا الإنسان تحت ضغط النصوع في مذهبيته وفطريتها وإنسانيتها إلى سوء الظن بمن يخالفه، والنظر إليه كخارج عن الدين والمنطق والعقل حين رفض هذه المذهبية أو بعض ما فيها، وكل هذا وغيره من ثمار المذهبية التي تُعلمنا أنْ ليس فيها شيء يصعب فهمه وقبوله إلا إذا كان رائدنا العناد والعنت والهوى!
ومن طريف تناقضات المذهبيات عندي أنها ترى مخالفها ظلوماً جائراً عن الجادة؛ لوضوح الحق فيها ونصوعه، ثم تنظر إلى أتباعها أصحاب هذا الحق الواضح والناصع نظرة الريبة والشك وسوء الظن، فتحول بينهم وبين أي انفتاح على مخالفيهم، أصحاب المذاهب الواضحة البطلان، والبينة العوار، وتسعى جاهدة عبر ممثليها أن ينأى المؤمنون بها عن ترهات الآخرين وغباواتهم، فإذا كان هذا شأنها، فأين دعواها في تلك الأوصاف التي تُطلقها على مذهبيتها؟ انظر إليها كيف أصبحت تشك في الإنسان، معها أو ضدها، وهي التي لا ترى بديلاً عنها يُقنع العالمين، ويهديهم سبيل الرشاد؟ إنها للأسف تدعي الإقناع، وهو شيء لم تستطع أن تدلل عليه من خلال موقفها من أقرب المقربين إليها حين شكت فيه، وجعلته تحت كاميرا المراقبة أن تزوغ عينه هنا أو هناك.
لا يستطيع إنسان المذهبية أن يفكر مجرد تفكير في حرية الإنسان، أيا كانت تلك الحرية، وذلك منه صورة واضحة على شكه في المؤمنين بمذهبيته، التي يراها خلاصة الدين ونصوصه، وهو لهذا يسعى إلى ضرب فكرة الحرية من البداية، فيجعلها وجها من وجوه غربنة المجتمع، فيقع بهذا التوصيف في تضليل أتباعه من وجهين؛ الأول تصوير الحرية كمفهوم غربي، ليس له وجود في تأريخ أمتنا، وهو شيء يُكذبه التأريخ بجلاء، ويكذبه تأريخ الإنسان المسلم مع نصوص دينه، والثاني نزع الغطاء الديني عن دعاة هذه الحرية، وإظهارهم بمظهر من يستند إلى الغرب وحده، ويسترشد بحياته، فتبدو الحرية كمفهوم دخيل على الثقافة الإسلامية، والحق عندي أنها دخيلة على الثقافة المذهبية، وليست الإسلامية، وهؤلاء المذهبيون في موقفهم مُحقون؛ لأنهم ينظرون من خلال كُوة المذهبية، وليس للحرية وجود في تأريخ المذهبيات، ولا في نصوصها؛ لكنهم أخطأوا حين خلطوا بين الإسلام ومذهبياتهم، فلعلهم ينظرون إلى الحرية من خلال رحابة الإسلام، لا ضيق المذهبية.
ولم يكتف إنسان المذهبية بغربنة قضايا الحرية الجديدة، وحجب الناس عن أن يفكروا فيها تفكيرا حراً، بل قصد، وهذا ما يكشف تمترسه بالمذهبية، ويُوضح غياب البوصلة عنده، ويفضح سعيه، إلى غربنة قضايا فقهية شهيرة، جرى فيها الخلاف بين المسلمين في القديم، وخير مثال على ذلك قضية حجاب المرأة المسلمة، حين أضحى من يقول بكشف وجه المرأة ساعياً من سُعاة تغريب المجتمع الإسلامي، وهكذا أضحى المذهبي يُعطّل نصوص الدين، ويحجب بعض منظومته من أجل أنّ هناك إنساناً يريد أن يتخذ هذه النصوص مدخلاً في تغريب المجتمع! وهكذا وقع المذهبي فيما يجهد للفرار منه، وهي التهمة التي ما زال هذا المذهبي يوجهها لمن يخالف بنود مذهبيته، ويستعين في بلوغ هدفه بمصطلح التغريب، نعم وقع المذهبي في الداهية التي يفر منها، وهي غربنة الإسلام، وقع فيها حين جعل للغرب دوراً في موقفه من نصوص دينه في قضية الحجاب، فهل يستطيع هذا المذهبي أن يُفسر كيف جاز له أن يتخذ الغرب حين نظره في النصوص، فيُوقف تلك النصوص المجيزة لكشف الوجه من أجل الغرب؟ وهل في مقدور هذا المذهبي أن يُفصح لنا عن الوقت الذي يجوز لنا أن نقول فيه بمقتضى تلك النصوص بعيداً عن غرب أو شرق؟!













 ]
]